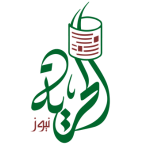محمد حامد جمعه يكتب عن سكان شمبات: ميلاد

أهلنا وأحبابنا الذين أجلاهم الجيش من شمبات الأراضي .مربعات مختلفة . وسحنات عديدة ومعاناة ومأساة واحدة . ظللت الصورة لأغراض الستر المباح ؛ وترفعا من مس كرام كان بعضهم من سمته ومحياه يدل عليه نبل السكينة والوقار .
وعز لم تهتكته عدايات الحرب لكن مزق صموده بؤس لئام . بعضهم لم يراعي فارق عمر لكهل في سن أبيه أو سيدة في مقام أمه . أحدهم كان في عثرة مرضه يهتم بأخرين في فصل بعيد يسأل لهم بعض الطعام من شباب قدم يفزع بالماء وبعض العدس .كان يلح في سد ثغرات التوزيع قال يخاطبني معتذرا والله أنا ما محتاج .
لكن في ذاك الفصل كرام يأنفون التزاحم ! أكمل عبارته بدمع كان يتحدر من مقلة حمراء على خد أسمر .منعها بطرف كمه وأكملت أنا تطوعا إدرارها على قلبي .
فجلست على بعض تل أقامه صغار كانوا يلعبون سألني أحدهم تبكي مالك يا عمو ! فلزمت الصمت وأصابعي تنقض شعيرات رأسه الصغير .
2
عجوز سبعيني جلس يمدد أرجله على رأحة ابن بار أو أظنه أبنه من خيوط الملامح . كهل حرص على جلباب ناصع . غطى رأسه بثوب أبيض .لا يتحدث .تنوب عن كلماته نظرة غيظ وحزن يكاد يفصح عن شعور بالأسى . يلمه حينما بلغ مجلسنا ضابط برتبة نقيب من الجيش .
من حميمية الإستقبال شعرت أن الجميع يجله .كبار .صغار .رجالا ونسوة . يشرق وجه الكهل .يلحظ الضابط إنتفاخ ساق العجوز فيستفسر ويدرك أن علامة طارئ صحي بانت فيطلب عربة إسعاف ليقول العجوز مرجيا حالته أنا كويس شوفو فلان ! ويشير لرفيق له مسجى بمكان غير بعيد .يقول أن حالته اولى بالإسعاف . يؤثرون على أنفسهم
3
لن أقص ما سمعت من عذابات أيام ما قبل الإجلاء .الغصة التي تسد حلوق الرجال مما شهدوا من نهب وسرقة وإبتزاز (مالك مقابل عرضك) ! لا تنحل تلك العبرات إلا بالحديث عن لحظات وصول الجيش . قال لي أحد اولئك الكرام من أهلنا كأننا قد ولدنا على حافة قبور الممات حين رايناهم وأخرجونا .
حين سمعت ما سمعت ورغم سابق تجربتي شعرت وكأني يقص علي وأنا في قاع الجحيم . حمدا لله على السلامة .
وكما قلت بحري ماها بعيدة ..فأنفروا لأهلكم